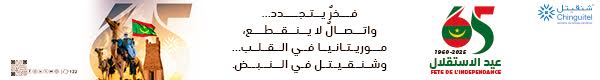مع استمرار قضية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وما نجم عنها من حروب على مدى أكثر من ثلاثة أرباع القرن، أصبحت من أكثر الصراعات اتساعا خارج ميادين القتال.
فقد توسعت أبعاد الصراع وامتدّت إلى لغة التوصيف والترميز وكذلك المصطلحات. وأصبحت من أكثر النزاعات تحدّيا للبلاغة الإنسانية خصوصا في مجال المصطلحات. ونظرا للخلافات السياسية والأيديولوجية التي يتضمنها ذلك الصراع، أصبحت المصطلحات التي تستخدم في مقال يكتبه إعلامي مستقل تختلف عما يستخدمه كاتب آخر منحاز لـ «إسرائيل» أو آخر يتبنى وجهة النظر العربية والإسلامية. ويتضح وجود حالة استقطاب بين الكتّاب، تتسع حسب الانتماء الأيديولوجي لكل منهم. فالكاتب الصهيوني المنحاز بشكل كامل للاحتلال يندر استخدامه لكلمة «فلسطين» ويتبنى لغة توصيفية تسعى لمصادرة كل ما هو فلسطيني وعربي، ويصر على استخدام المصطلحات الإسرائيلية، رغبة منه في النيل من مصداقية الخطاب العربي والفلسطيني.
وليكن البدء بكلمة «فلسطين» وهي الأرض التي كانت مهد الصراع وما تزال. فالإسرائيليون يرفضون إطلاق هذا الاسم على كل الأراضي التي أقيمت عليها «إسرائيل». بينما على الجانب الآخر يرفض مفكرون وكتّاب استخدام كلمة «إسرائيل» اسمًا لما يعتبرونه «فلسطين». وبرغم سياسات التطبيع ومحاولات إزالة الحواجز ما يزال الانتماء الأيديولوجي يفرض نفسه على الفرقاء. فلا تستخدم كلمة «إسرائيل» إلا نادرا، بينما تعج كتابات الملتزمين بالقضية من وجهة النظر الفلسطينية والعربية والإسلامية بكلمة «فلسطين». ويرفض البعض إطلاق مصطلح «دولة إسرائيل» ويستخدم مكانها «كيان الاحتلال». فلا يتم الاعتراف بوجود دولة للمحتلين، بل يعتبر وجود الصهاينة على أرض فلسطين احتلالا. وفي المقابل لدى المستوطنين ما يميز لغتهم، فيرفضون استخدام «فلسطين» ويبالغون في استخدام «إسرائيل» لتسمية البقعة التي يدور الصراع بشأنها. فما بين كلمتي «دولة» و «احتلال» بون شاسع من الاختلاف السياسي والأيديولوجي يجعل أية محاولة لتقريب وجهات النظر أو البحث عن مشتركات نوعا من اللغو وإضاعة الوقت. إنه التزام أيديولوجي للكاتب الصهيوني الذي لا يرى غير «إسرائيل» في الخريطة السياسية، بينما لا يرى الكاتب العربي، وجودا لـ «إسرائيل». وهذه حقيقة استمرت منذ العام 1948 وما تزال تفرض نفسها على الصراع المتعدد الجبهات والأشكال.
وهناك مصطلح «السامية» الذي تعتبره «إسرائيل» خاصا بها، بمعنى أن الإسرائيليين ينحدرون من سلالة سام بن نوح.
وسام هو أبو العرب والروم والفرس وهم الذين يقال لهم الساميون، واليهود من الروم. ولأن العرب ينحدرون من سام أيضا، فهم أيضا ساميّون. ولكن تقوم الدنيا ولا تقعد إذا هوجم اليهود باعتبارهم ساميين، ولا يحدث الأمر نفسه إذا تعرّض العرب للهجوم. هذه الازدواجية في المواقف لا تؤدّي لإنسانية متسامحة ومتفاهمة. وما أكثر المصطلحات التي تختلف المواقف بشأنها. فحين يُقتل الفلسطينيون المدنيون بالاعتداءات الإسرائيلية يطلق على ذلك مصطلح «الخسائر المصاحبة للحرب» ولا يمثل ذلك جريمة، ويتم تحاشي استخدام مصطلح «الإبادة» التي هي الأصح، حسب ما تكرر في بيانات صدرت عن مجلس حقوق الإنسان وبعض الجهات الدولية. ولعل المصطلح الأكثر إثارة للاستغراب ما يرتبط باستخدام القوّة في الصراعات المسلحة. وهنا تتعرض المصطلحات للتشويش بشكل مجحف.
فمن يمارس العنف لمواجهة نظام أو جهة صديقة للغرب يطلق عليه «إرهابي» أما التصدي بالسلاح لطرف غير صديق للغرب فيعتبر «مقاومة». الخط الفاصل هنا بين المقاومة والإرهاب يرتبط بطبيعة الهدف وهويته وانتمائه وليس بالفعل الذي يمارس ضده. فالفلسطيني الذي يسعى لتحرير وطنه «إرهابي» بينما الذين يقاتلون ضد القوات الروسية في أوكرانيا فهم «مقاومون». وحتى أسماء المناطق تخضع للاختلافات الأيديولوجية والسياسية. فالجانب العربي والفلسطيني يستخدم اسم «الضفة الغربية» التي تشمل جبال نابلس وجبال القدس وجبال الخليل والشطر الغربي من غور الأردن، بينما يصر الإسرائيليون على تسميتها «يهودا والسامرة». وحتى قضية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين تخضع للمواقف والسياسات. فمن وجهة نظر العرب والمسلمين، تسمى «قضية الشرق الأوسط» أي أنها تخص دول المنطقة وشعوبها ويُفترض أن تشارك فيها هذه الأطراف، بينما يطلق الغربيون عليها مصطلح «الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي» لحصرها بالطرفين. هذا مع العلم أن «إسرائيل» ليست وحدها في الصراع، بل أنها مدعومة بشكل كامل من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية. وتلتزم أمريكا بمبدأ «الحفاظ على أمن إسرائيل» سياسيا وعسكريا. ومصطلح الشرق الأوسط نفسه مصطنع من قبل الغربيين الذين استعمروا العالم وأطلقوا تسميات على المناطق الأخرى على اساس موقعها الجغرافي بالنسبة لهم.
هذه المفارقات في المصطلحات لا تنحصر آثارها بالجانب اللفظي فحسب، بل أن لها مدلولات وتبعات عملية. وعلى أساس ذلك يحدد الغربيون مواقفهم وسياساتهم. فحين تم الإعلان يوم الخميس الماضي عن قتل 22 فلسطينيا بينهم اثنان في كنيسة كاثوليكية كان رد الفعل بأشكال عديدة. فالقتلى الفلسطينيون لا يحظون باهتمام العالم الغربي، لأنهم أصبحوا أرقاما تضاف إلى أرقام عشرات القتلى الذين يقتلون يوميا عندما يتوجهون إلى مراكز الإغاثة للحصول على الطعام بعد انتشار المجاعة. بينما اهتمت الكنيسة بالقتلى الاثنين، وهذا أمر طبيعي، مع أن قتل نفس واحدة، أيا كانت هويتها أو انتماؤها او دينها أو عرقها، جريمة يجب أن لا تحدث، ومن يرتكبها يجب أن يحاكم كقاتل. ولا بد من الإشادة بتصرح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني التي قالت في بيان “الهجمات التي تشنها إسرائيل على السكان المدنيين منذ أشهر غير مقبولة. لا يمكن لأي عمل عسكري أن يبرر مثل هذا السلوك”. هذا البيان ضروري ولكنه غير كاف لأنه لا يمثل ضغطا حقيقيا على «إسرائيل» التي تتحدى العالم ما دامت تشعر بأمن من ردود فعل حقيقية: سياسية أو عسكرية أو اقتصادية.
الحروب الصغيرة تنتهي عادة بدون أن ينجم عنها أو يرتبط بها ثقافة ذات لون أو طعم، ولا تتمخض عنها مصطلحات ذات مغزى. أما الصراعات الطويلة الأمد فكثيرا ما ينجم عنها نزاعات لتأصيل الخلاف او تقعيده. والصراع من أجل فلسطين يعتبر الأطول في التاريخ المعاصر للمنطقة، وقد نجم عنه ثقافة ونزاعات سياسية وقيم نضالية تجاوزت حدود المنطقة، وأصبح لها أصداء في أنحاء العالم. وبشكل تدريجي تحوّلت إلى أيقونة نضالية هي الأطول في التاريخ الحديث. بينما النزاعات الأخرى تلاشت آثارها وإن كانت لها دلالات أيديولوجية كبيرة. ومن ذلك ما حدث في جنوب آسيا في الستينيات والسبعينيات، من صراع مرير مع الاحتلال الأمريكي في سايغون ولاوس وفيتنام. يومها كان للصراع طعمه الأيديولوجي في ذروة الحرب الباردة بين الشيوعية والرأسمالية وتجلياتهما الإقليمية. وبعد ذلك حدثت أزمة أفغاننستان وما تمخص عنها من حرب بين مجموعات «المجاهدين» والقوات الأمريكية، وكان لذلك الصراع انعكاسات إقليمية وصلت ألى الشمال الأفريقي، وتمخضت عنها مجموعات أطلق عليها مصطلح «الأفغان العرب». وقبل ذلك كان للأزمة الكوبية تداعياتها في أنحاء عديدة من العالم، وبرز نجم «تشي غيفارا» كمناضل أممي يمثل عالمية «الشيوعية» واستعداد مناضليها لخوض الحروب في الغابات والأدغال ضد ما اصطلح على تسميته «القوى الإمبريالية». ولم يكن الصراع مع «إسرائيل» غريبا عن تلك المعمعمة الفكرية والأيديولوجية. فقد كانت ساحة للنضال الأممي خصوصا في أشكاله الفكرية والأيديولوجية. وأصبحت القضية الفلسطينية ساحة للسباق بين الاتجاهات المختلفة، ومصدر إشعاع ثوري كاد يعصف بالمنطقة وكياناتها السياسية.
في هذه الفسيفساء السياسية والنضالية احتدمت معارك المصطلحات والترميز، وكانت في لحظة تاريخية مهمة، إحدى تجلّيات الصراع الأيديولوجي بين ما كان يعتبر «الشرق الشيوعي» و«الغرب الرأسمالي». وبعد تراجع الحرب الباردة بتفكك الاتحاد السوفياتي، اختلفت أيديولوجية الصراع الدولي، وطرحت مصطلحات لتوصيف النزعات الإسلامية التي تصدّت لمقاطع عديدة من الصراع في مناطق مختلفة من العالم. ومن المؤكد أن يكون لاستخدام المصطلحات انعكاساته ونتائجه الميدانية. فكما أن الترميز ينعكس في حركة الشارع، وقد يؤدي لسجن الأفراد لرفعهم إشارات أو رموز ذات دلالات غير مرغوبة لدى النظام السياسي القائم، فإن المصطلحات، هي الأخرى، لها تبعاتها وانعكاسات على العلاقات خصوصا بين الأنظمة السياسية وأطرف النضال المضاد. وهكذا تصبح المصطلحات وجها آخر للتفاعل بين الدول والحضارات.
كاتب بحريني
نقلا عن القدس العربي